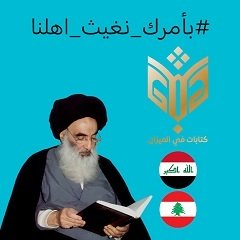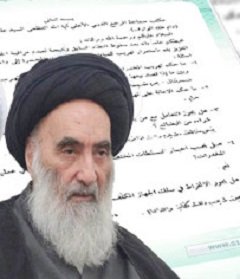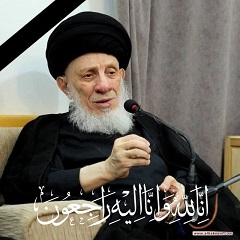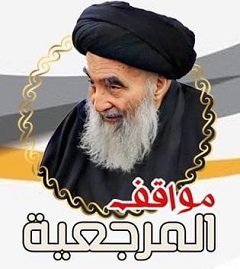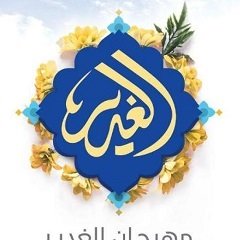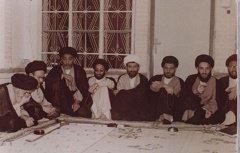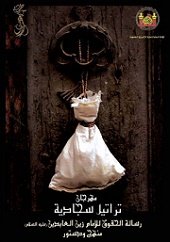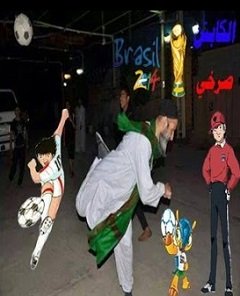كانت لغة أبي فراس تتميز بالوضوح والإبانة، وبعيدة عن التكلف والتعقيد، مسلوقاً لطبعه وظروفه، فحيناً تكون لغته عذبة بسيطة، وحيناً آخر تكون يدوية جزلة، وبخاصة عندما يجاري الأقدمين في فخره، أو في أي موضوع تقليدي آخر، فهو عندما يؤسّس شعره على أن يأتيَ فيه الكلام البدوي الفصيح، لايخلط به الحضري المولد؛ فأبو فراس كان بعيداً عن التعقيد والغموض، وهو أمر يمكن رده الى ثقافته العربية الخالصة، والى أثر بيئته التي عاش فيها، فهو لم يتعلق بتاتا بالثقافات الأجنبية، ولم يشغف بالفلسفة والعلوم الأوائل.
يحرص أبو فراس على أن تكون لغته بريئة صافية من الثقل حتى تكون قريبة من الأسماع والقلوب. وقد حذر العلماء الأوائل والنقاد القدماء من الوعورة في اللغة الشعرية؛ لأنها تأتي بعكس المراد، كما فعل أبو هلال العسكري إذ قال: (إياك والتوعر، فان التوعر يسلمك الى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك).
ولأبي فراس عدة وسائل تساعده على أن يؤدي دوراً تعبيرياً واضحاً في القصيدة، منها: التكرار والتضمين والاقتباس. والتكرار وسيلة من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي دوراً تعبيرياً في القصيدة؛ فتكرار لفظة ما، أو عبارة ما، يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر. وللتكرار وظيفه إيحائية هامة، وله صور وأشكال عديدة منها: البسيط الذي لايتجاوز تكرار لفظه، أو عبارة، ومنها المركب الذي يمزج التكرار المعنوي بعناصر لغوية أخرى، أو يكرر بيتاً برمته سوى عروضه وقافيته.. وأمثلة التكرار عديدة في شعر أبي فراس، حتى أنها تمثل خصيصة مميزة لأسلوبه، وهو يكشف عن رغبة الشاعر في التأكيد على المعنى الذي يسوقه، والإلحاح عليه، من مثل قوله الذي كرر فيه عدة ألفاظ بعينها في بيت واحد:
وهل يُطلب العزُّ الذي هو غائبُ * ويُتركُ ذا العز الذي هو حاضرُ
وفي قوله الذي كرر فيه شطرا دون القافية:
وهل لقضاء الله في الخلق غالب * وهل لقضاء الله في الخلق هارب
ومن الخصائص الأسلوبية المميزة في شعر أبي فراس كثرة ميله الى الاقتباس والتضمين.. وأكثر اقتباسه من القرآن الكريم في مثل قوله:
وما كلف الإنسان إلا وسعه * واللهُ نصّ بذاك في القرآن
وقد سار أبو فراس في شعره كله وفق المستوى اللغوي الأمثل المعروف لدى معاصريه، فحرص على سلامة الاستعمال اللغوي قدر طاقته، ومن ثم عد شعره في جملته موافقاً لمستوى الصواب المتفق عليه في استعمالات اللغة، إلا أن شعره لم يسلم من بعض هنوات وقع فيها اضطراراً أو تجاوزاً؛ وللحق فان هذه الهنوات – وهي قليلة بالقياس الى سعة شعره – كان في عهد الشدو قد وقع فيها اضطراراً أو استجابة للضرورة الشعرية، كصرف الممنوع من الصرف، وقصر الممدود، وتسهيل الهمز، أو وقع فيها تجاوزا لقلة خبرته آنذاك بأسرار اللغة..! ومن أمثلة الضرورات الشعرية صرفه (لمكة، ولعبد يغوث)، وهما ممنوعان من الصرف، وذلك في قوله:
وقد مات محبوساً ريانُ بنُ منذر * وباع بأعلى مكة بيع كاســـــــدِ
وعبد يغوث بعد طول ثوائــــــه * قضى راشد الأفعال أو غير راشدِ
ومن أمثلة صرف الممنوع من الصرف قوله:
وخرقاءٌ ورقاءٌ بطيءٌ كلالُها * تكلفُ بي مالا تطيقُ الأباعرُ
فقد صرف ورقاء وحقها أن تُمنع.
أما تسهيل الهمز فيكثر الوقوع في شعره؛ ومعروفاً أن القبائل العربية لا تتفق في تحقيق الهمز وتسهيله، وان تحقيقه من خصائص (تميم) في حين تتخلص منه (قريش) بالحذف أو التسهيل أو القلب أو المد، وتحقيق الهمز خصيصة لغوية تتميز بها تميم وغيرها من قبائل وسط الجزيره العربية، إلا أن هذه القاعدة مطردة تماما، فكثيراً ما يتحكم الوزنُ الشعري في اللغة، فيجعل الكلمات المهموزة الى كلمات خالية من الهمز، ومن ثم فان هذا لايُعد عيباً كما ذهب إليه (ابن قتيبة). أما ما سقط فيه أبو فراس من الأخطاء اللغوية تجوزا فقليل نادر، ولا يعدو أن يكون متعلقا بوجه من وجوه الصواب في الاستعمال؛ ولعل أبرز هذه السقطات، ما جعل فيه فاعلين للفعل، أو كما يقول النحاة: لغة (أكلوني البراغيث)، في مثل قوله:
تخالط فيها الجحفلان كلاهما * فغبن القنا عنها ونبن البواتر
والحقيقة، إننا لانستطيع أن نُؤاخذ أبي فراس على هذه السقطات، فجمالية الروميات تفرض علينا أن نغض الطرف عن ذلك.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat