يوم القضاء العراقي: 23 يناير (ح 1) (ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)
د . فاضل حسن شريف
 المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . فاضل حسن شريف
عن موقع مجلس النواب: قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى: 12 كانون الثاني, 2017: بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الآتي: رقم ( 45 ) سنة 2017 قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى: المادة ـــ 1 ـــ يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ومقره في بغداد. المادة ـــ 2 ـــ اولاً:-: يتألف مجلس القضاء الأعلى من: 1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيساً 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - أعضاء 3. رئيس الادعاء العام - عضواً 4. رئيس هيئة الأشراف القضائي - عضواً 5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - أعضاء 6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - أعضاء ثانياً: يحل أقدم أعضاء المجلس، محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان. المادة ـــ 3 ـــ يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الاتية: أولاً- إدارة شؤون الهيئات القضائية. ثانياً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها. ثالثاً- ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة. رابعاً:- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها. خامساً:- ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها. سادساً:- ترشيح المؤهلين للتعين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك. سابعاً:- ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم واعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقاً للقانون. ثامناً:- تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد وفقاً للقانون. تاسعاً- تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية. عاشراً- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية. حادي عشر: عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل. ثاني عشرة:- تأليف لجنة شؤون القضاة وفقاً للقانون.
المادة ـــ 4 ـــ للمجلس أن يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس. المادة -5- أولاً- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانياً - يسمي رئيس المجلس مقرراً للمجلس، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله، وتدوين محاضره، وتحرير مخاطباته، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. المادة -6-:- تتكون الإدارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية: اولاً:- دائرة شؤون القضاة. ثانياً:- دائرة الشؤون المالية والادارية. ثالثاً:- دائرة المحققين والمعاونيين القضائيين. رابعاً:- دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية. خامساً:- دائرة الحراسات القضائية العامة. سادساً:- معهد التطوير القضائي. سابعاً:- المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى. ثامناً:- قسم التدقيق المالي والرقابة الداخلية. المادة ــــ 7 ــــ اولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6/اولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً/خامساً) من هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل. ثانياًـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان (معاون مدير عام) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام. ثالثاً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الأقل وحاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. المادة ـــــ 8 ـــــ تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى. المادة ــــــ 9 ـــــ يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ـــ 10 ـــ يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (35) لسنة 2003. المادة ـــ 11ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة: بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور. شرع هذا القانون نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4432 الصادرة في 23 كانون الثاني 2017.
جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ" (الأنعام 57) قوله تعالى: "قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ" إلى آخر الآية. البينة هو الدلالة الواضحة من البيان وهو الوضوح، والأصل في معنى هذه المادة هو انعزال شيء عن شيء وانفصاله عنه بحيث لا يتصلان ولا يختلطان، ومنه البين والبون والبينونة وغير ذلك، قد سميت البينة بينة لأن الحق يبين بها عن الباطل فيتضح ويسهل الوقوف عليه من غير تعب ومئونة. والمراد بمرجع الضمير في قوله: "وَكَذَّبْتُمْ بِهِ" هو القرآن وظاهر السياق أن يكون التكذيب إنما تعلق بالبينة التي هو (صلَّ الله عليه وآله) عليها على ما هو ظاهر اتصال المعنى، ويؤيده قوله بعده: "ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ" إلخ، فإن المحصل من الكلام مع انضمام هذا الذيل: أن الذي أيد الله به رسالتي من البينات وهو القرآن تكذبون به، والذي تقترحونه علي وتستعجلون به من الآيات ليس في اختياري ولا مفوضا أمره إلي فليس بيننا ما نتوافق فيه لما أني أوتيت ما لا تريدون وأنتم تريدون ما لم أوت. فمن هنا يظهر أن الضمير المجرور في قوله: "وَكَذَّبْتُمْ بِهِ" راجع إلى البينة لكون المراد به القرآن، وأن قوله: "ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ" أريد به نفي التسلط على ما يستعجلون به بالتكنية فإن الغالب فيما يقدر الإنسان عليه وخاصة في باب الإعطاء والإنفاق أن يكون ما يعطيه وينفقه حاضرا عنده أو مذخورا لديه وتحت تسلطه ثم ينفق منه ما ينفق فقد أريد بقوله: "ما عِنْدِي" نفي التسلط والقدرة من باب نفي الملزوم بنفي اللازم. وقوله: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" إلخ، بيان لسبب النفي، ولذلك جيء فيه بالنفي والاستثناء المفيد للحصر ليدل بوقوع النفي على الجنس على أن ليس لغيره تعالى من سنخ الحكم شيء قط وأنه إلى الله سبحانه فحسب.
ويستطرد العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره الآية المباركة الأنعام 57 قائلا: (كلام في معنى الحكم وأنه لله وحده) مادة الحكم تدل على نوع من الإتقان يتلاءم به أجزاء وينسد به خلله وفرجه فلا يتجزى إلى الأجزاء ولا يتلاشى إلى الأبعاض حتى يضعف أثره وينكسر سورته، وإلى ذلك يرجع المعنى الجامع بين تفاريق مشتقاته كالإحكام والتحكيم والحكمة والحكومة وغير ذلك. وقد تنبه الإنسان على نوع تحقق من هذا المعنى في الوظائف المولوية والحقوق الدائرة بين الناس فإن الموالي والرؤساء إذا أمروا بشيء فكأنما يعقدون التكليف على المأمورين ويقيدونهم به عقدا لا يقبل الحل وتقييدا لا يسعهم معه الانطلاق، وكذلك مالك سلعة كذا أو ذو حق في أمر كذا كان بينه وبين سلعته أو الأمر الذي فيه نوعا من الالتيام والاتصال الذي يمنع أن يتخلل غيره بينه وبين سلعته بالتصرف أو بينه وبين مورد حقه فيقصر عنه يده، فإذا نازع أحد مالك سلعة في ملكها كأن ادعاه لنفسه أو ذا الحق في حقه فأراد إبطال حقه فقد استوهن هذا الإحكام وضعف هذا الإتقان ثم إذا عقد الحكم أو القاضي الذي رفعت إليه القضية الملك أو الحق لأحد المتنازعين فقد أوجد هناك حكما أي إتقانا بعد فتور، وقوة إحكاما بعد ضعف ووهن، وقوله: ملك السلعة لفلان أو الحق في كذا لفلان حكم يرتفع به غائلة النزاع والمشاجرة، ولا يتخلل غير المالك وذي الحق بين الملك والحق وبين ذيهما، وبالجملة الآمر في أمره والقاضي في قضائه كأنهما يوجدان نسبة في مورد الأمر والقضاء يحكمانه بها ويرفعان به وهنا وفتورا، وهو الذي يسمى الحكم. فهذه سبيل تنبه الناس لمعنى الحكم في الأمور الوضعية الاعتبارية ثم رأوا أن معناه يقبل الانطباق على الأمور التكوينية الحقيقية إذا نسبت إلى الله سبحانه من حيث قضائه وقدره فكون النواة مثلا تنمو في التراب ثم تنبسط ساقا وأغصانا وتورق وتثمر وكون النطفة تتبدل جسما ذا حياة وحس وهكذا كل ذلك حكم من الله سبحانه وقضاء، فهذا ما نعلقه من معنى الحكم وهو إثبات شيء لشيء أو إثبات شيء عند شيء.
ويستمر السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان للآية الأنعام 57: ونظرية التوحيد التي يبني عليها القرآن الشريف بنيان معارفه لما كانت تثبت حقيقة التأثير في الوجود لله سبحانه وحده لا شريك له، وإن كان الانتساب مختلفا باختلاف الأشياء غير جار على وتيرة واحدة كما ترى أنه تعالى ينسب الخلق إلى نفسه ثم ينسبه في موارد مختلفة إلى أشياء مختلفة بنسب مختلفة، وكذلك العلم والقدرة والحياة والمشية والرزق والحسن إلى غير ذلك، وبالجملة لما كان التأثير له تعالى كان الحكم الذي هو نوع من التأثير والجعل له تعالى سواء في ذلك الحكم في الحقائق التكوينية أو في الشرائع الوضعية الاعتبارية، وقد أيد كلامه تعالى هذا المعنى كقوله: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" (الأنعام 57) (يوسف 67) وقوله تعالى: "أَلا لَهُ الْحُكْمُ" (الأنعام 62) وقوله: "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ" (القصص 70) وقوله تعالى: "وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ" (الرعد 41) ولو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقب حكمه ويعارض مشيته، وقوله: "فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ" (غافر 12) إلى غير ذلك، فهذه آيات خاصة أو عامة تدل على اختصاص الحكم التكويني به تعالى. ويدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعي به تعالى قوله: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" (يوسف 40) فالحكم لله سبحانه لا يشاركه فيه غيره على ظاهر ما يدل عليه ما مر من الآيات غير أنه تعالى ربما ينسب الحكم وخاصة التشريعي منه في كلامه إلى غيره كقوله تعالى: "يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ" (المائدة 95) وقوله لداود عليه السلام: "إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" (ص 26) وقوله للنبي صلَّ الله عليه وآله: "أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ" (المائدة 49) وقوله: "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ" (المائدة 48) وقوله: "يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ" (المائدة 44) إلى غير ذلك من الآيات وضمها إلى القبيل الأول يفيد أن الحكم الحق لله سبحانه بالأصالة وأولا لا يستقل به أحد غيره، ويوجد لغيره بإذنه وثانيا، ولذلك عد تعالى نفسه أحكم الحاكمين وخيرهم لما أنه لازم الأصالة والاستقلال والأولية فقال: "أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ" (التين 8) وقال "وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ" (الأعراف 87). والآيات المشتملة على نسبة الحكم إلى غيره تعالى بإذن ونحوه كما ترى تختص بالحكم الوضعي الاعتباري، وأما الحكم التكويني فلا يوجد فيها ـ على ما أذكر ـ ما يدل على نسبته إلى غيره وإن كانت معاني عامة الصفات والأفعال المنسوبة إليه تعالى لا تأبى عن الانتساب إلى غيره نوعا من الانتساب بإذنه ونحوه كالعلم والقدرة والحياة والخلق والرزق والإحياء والمشية وغير ذلك في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها. ولعل ذلك مراعاة لحرمة جانبه تعالى لإشعار الصفة بنوع من الاستقلال الذي لا مسوغ لنسبته إلى هذه الأسباب المتوسطة كما أن القضاء والأمر التكوينيين كذلك، ونظيرتها في ذلك ألفاظ البديع والبارئ والفاطر وألفاظ أخر يجري مجراها في الإشعار بمعاني تنبئ عن نوع من الاختصاص، وإنما كف عن استعمالها في غير مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبية.
جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن القضاء (الفقه): لقضاء هو الفصل بين النّاس في الخصومات التي تقع بينهم بالأحكام الشرعيّة الثابتة من الكتاب والسنّة، ويقسم القضاة إلى: القاضي المنصوب، والقاضي الاضطراري، وقاضي التحكيم، وقاضي الأمر بالمعروف، ويشترط في القاضي مجموعة من الشروط وهي: البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، طهارة المولد، العدالة، الرشد، الإجتهاد، ويوجد مجموعة من الوسائل التي حددها الشارع المقدس للقاضي ليعتمد عليها للإثبات في الدعاوى وحل الخصومة وهي: البينة الشرعية، اليمين، الإقرار، علم القاضي نفسه، القرعة، ولا يجوز للقاضي أخذ الأجرة على القضاء. مشروعيته: استدل الفقهاء على مشروعية القضاء بالقرآن الكريم كقوله تعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ" (المائدة 49) وغيرها من الآيات الشريفة،قال الله جل جلاله "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء 65)، "وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ" (النور 48)، "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (النور 51) والسنة الشريفة الفعلية منها: بعث رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم عليّاعليه السلام قاضيا إلى اليمن، وبعث عليّعليه السلام عبد الله بن عباس قاضيا إلى البصرة، وقد دلت الكثير من الروايات على مشروعيته أيضا. حكمه: ذكر الفقهاء أنَّ القضاء واجب كفائي، وذكروا أن حكم القاضي نافذ على الجميع ولا يجوز نقضه من قبل قاض آخر إلا مع فرض فقدان القاضي الأول للشروط المعتبرة في القاضي أو فرض مخالفة حكمه لما ثبت بنحو القطع من الكتاب والسنة الشريفين. فرقه عن الفتوى: قال السيد الخوئي: الفرق بينه أي: القضاء وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكليّة من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي أي الفتوى لا تكون حجّة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي. وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat







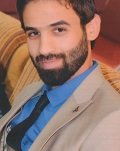



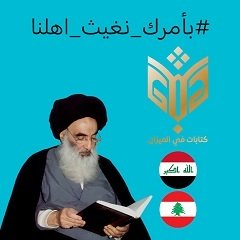
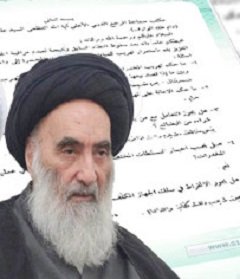

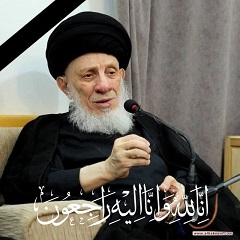

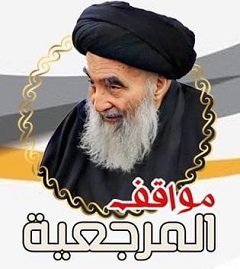



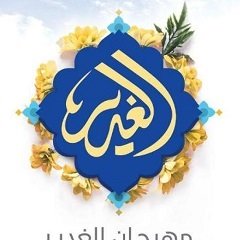


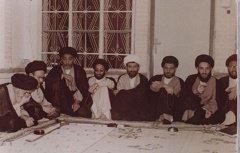
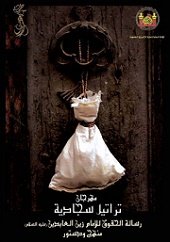




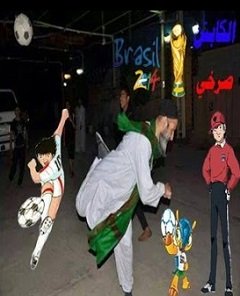




.jpg)



